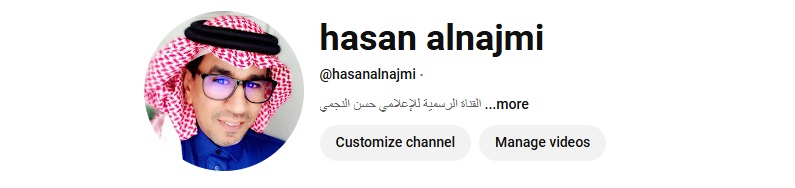في زوايا القاهرة القديمة، وتحديدًا في حي باب الشعرية، وُلد محمد عبدالوهاب عام 1902، وسط بيئة شعبية محافظة، لا تعترف بالفن طريقًا ولا بالموسيقى علمًا. كان الفتى الصغير يختبئ خلف أبواب الخوف ليحاكي أصوات المنشدين، ويغني بصوت خافت لا يسمعه إلا قلبه. من هناك، بدأت أولى خيوط الرحلة الطويلة التي ستقوده ليصبح أحد أعظم من أنجبتهم الموسيقى العربية.
البدايات.. صوت من خلف الستار
نشأ عبدالوهاب في كنف أسرة دينية، وكان والده يعمل مؤذنًا. لكن شغفه بالفن والموسيقى دفعه للانضمام إلى فرقة مسرحية صغيرة في عمر التاسعة، يغني فيها خلف الستار خشية أن يُكتشف أمره. في تلك اللحظات المبكرة، كان يصوغ حلمه الخاص بأن يكون صوتًا يُسمع لا يُخفى.
شوقي.. اليد التي فتحت له أبواب المجد
اللقاء الذي غيّر حياته كان مع أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي تبنّاه فنيًا وأدبيًا، وفتح له أبواب المجتمع الراقي، وعلّمه الفصاحة والتعبير. بتأثير شوقي، بدأ عبدالوهاب مسيرة جديدة في تلحين القصائد الكلاسيكية، فغنّى “كليوباترا” و”الجندول” و”النهر الخالد” بأداء درامي راقٍ جمع بين قوة النص وجمال الموسيقى.
عبدالوهاب المجدد.. حين انحنت الآلات للحن
لم يكن عبدالوهاب مجرد ملحن تقليدي يسير على خطى من سبقوه، بل كان مفكرًا موسيقيًا، ومغامرًا لا يخشى الانتقال من ضوء العود إلى ظلال التشيلو، ومن إيقاع الطبلة إلى وقع الأكورديون. أدخل الآلات الغربية إلى الأغنية العربية، وغيّر من شكل التوزيع الموسيقي، دون أن يُفقده هويته الشرقية. كان يُنصت إلى العالم، ثم يترجمه بطريقته الخاصة.
السينما.. حين عزف الصورة
في ثلاثينيات القرن الماضي، دخل عبدالوهاب عالم السينما ببطولة أفلام مثل “الوردة البيضاء”، “دموع الحب”، و”يحيا الحب”. لم يكن ممثلًا محترفًا، لكنه كان يعلم أن السينما نافذة جديدة للصوت، فكانت أفلامه محطات غنائية أكثر منها سردًا دراميًا. وقدّم في تلك الأعمال مجموعة من أجمل أغنياته، التي لا تزال حيّة في ذاكرة الأجيال.
التعاون مع الكبار.. أم كلثوم وأهواك
طوال عقود، بقي الجمهور يحلم بلقاء موسيقي يجمع بين عبدالوهاب وأم كلثوم، وكان التنافس بينهما مادة للصحافة. حتى جاء عام 1964، ليقدّم لها أول ألحانه في أغنية “أنت عمري”، فكان اللقاء التاريخي الذي جمّع جمهورين متنافسين في نشوة واحدة.